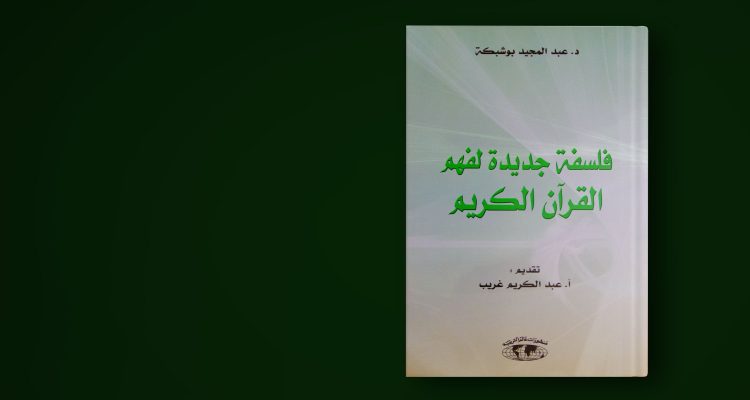مصطلح الخدمة الإيمانية عند الأستاذ كولن يحتاج لوحده أن يفرد بكتاب خاص. ذلك أن التجديد عند هذا الرجل يعد بصمة يضعها على كل أعماله وفي كل المجلات. أما بخصوص مصطلح “الخدمة الإيمانية” وباقتضاب شديد، فهو عنده يقارب دلالة مصطلح “الدعوة الإسلامية” إلا أنه لكنه أكثر استيعابا وعمقا منه. فإذا كان هَمُّ عدد من المصلحين والدعاة هو دعوة الناس إلى الدين الإسلامي ورحمته الواسعة، فإن الأستاذ كولن يتجاوز ذلك إلى خدمة الناس كل الناس بدون حدود، وما دعوتهم إلى رحمة هذا الدين إلا جزء من تلك الخدمة اللامتناهية، التي يدعو إليها الأستاذ فتح الله.هذا المعنى الواسع للخدمة الإيمانية عند الأستاذ كولن، يعد بمثابة الشهيق والزفير الذي لا يفارق الإنسان ما دام حيا.معنى الخدمة الإيمانية عند الأستاذ كولن، خالط عنده الإحساس والشعور حتى أصبح هما ثقيلا، وتجاوز العلم إلى العمل إلى أن صار واقعا ملموسا، وبات سمة بارزة من سمات منهجه الإصلاحي الذي يستصحبه خدمة لكل إنسان وسعيا في كل مكان.
ونحن نطل على عصر جديد من عصور الإنسانية، يرى الأستاذ كولن أن لله تعالى له حكما بليغة في اختياره لنبي ولكتاب بمواصفات معينة. وعلى أن لهذا القرآن خصائص يعز وجودها في غيره من الكتب، لذلك ستكون خسارة الإنسانية كبيرة حين تتجاهل هذا الكتاب ولا تضعه في المكان اللائق به.و يكون البعد عنه سببا في كثير مما يحدث من الظلم والتجاوز والجهالة.
لكل هذه الأسباب وغيرها يدعو الأستاذ كولن إلى التلطف مع المخالفين خاصة من غير المومنين لأنهم في النهاية جزء من هذه الإنسانية، ولأن عصرنا الحالي هو عصر الحوار والإقناع والكلمة. ولأنه عصر إنساني جديد باهض الكلفة، فإن مواصفات الجيل المنتظر كذلك، يجب أن تكون عالية الجودة.
في سبيل هذه الغايات يرى الأستاذ كولن أن شروط الاستفادة من القرآن الكريم تحتاج إلى روية وبعد نظر، وعدم التعويل على ظاهر الآي فقط. فتأمل قوله بخصوص الآية: ﴿قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا﴾قد يكون هذا السد ….ونحن نرى بأن علينا البحث عن أحكام كلية في قصة ذي القرنين، مثل شروط بقاء الدولة ودوامها وشروط رئيس الدولة… الخ، وبعكس هذا فإننا نكون قد قمنا فقط برواية حادثة من ثنايا تاريخ بعيد، وهذا يعني أننا نستطيع الاستفادة من القرآن استفادة كبيرة، أو أن هذه الاستفادة ستكون ضئيلة جداً.
و لأن التاريخ يعيد نفسه لابد لمن يتصدى لخدمة الإنسان من أصحاب الخلال الخاصة، ورثة الأرض، أن يستفيدوا من قصة ذي القرنين بخصوص إعانة العاجزين. وذلك لأن التاريخ يعيد نفسه. وعلى هؤلاء أن يجهزوا أنفسهم للوقوف في وجه كل الظالمين والمعتدين المنتشرين في كل مكان، ومؤازرة المظلومين والمحرومين. مستلهمين العبر من ذي القرنين الذي لم يتردد في الوقوف أمام هؤلاء المفسدين الطغاة أعداء الدين والعرض والملة. وسيتكرر التاريخ في هذا الخصوص وسيقوم مَنْ يرثون الأرض بإيقاف أمثال هؤلاء عند حدهم في كل عهد ﴿حَتّى إذَا فُتِحَتْ يَأجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلّ حَدْبٍ يَنْسِلُون﴾ أي أن ذلك السد القوي المتين سينهار وسيقوم المفسدون الظالمون من ذرية هذا القوم الظالم بالانتشار في جميع السهول والبراري والبلدان.
ولأن القرآن الكريم وضع أسسا ونظاما للحياة، عرفها من عرف وجهلها من جهل، فإن البعد عن تلك الأسس هو ضياع للإنسانية، نتيجة بعد الأجيال عن المسار الصحيح وتيه الإنسان في البحث عن أنظمة بديلة: “…كما قام القرآن الكريم بوضع بعض الأسس التربوية. ولكن عندما تركت هذه الأسس التربوية القرآنية وجرّبت النظم التربوية الأخرى التي وضعها علماء النفس وعلماء الاجتماع، رأينا أجيالاً من الشباب الضائع الغارق في المشاكل والمضطرب في تيار الأهواء ونوازع النفس. وستبقى الإنسانية تتجرع الآلام وتعيش في الأزمات طالما كانت بعيدة عن أسس التربية القرآنية. ولكن عندما تتصادق الإنسانية مع القرآن ستفهمه وتدرك مراميه وتستسلم له فتصل إلى شاطئ الأمن والطمأنينة..”
إن ما يجعل هذا القرآن كتابا ومنهجا إنسانيا هو نظرته العجيبة إلأى كل العصور والأزمنةعلى شدة تباينها، نظرة عامة وكأنه نزل بخصوصها. بل في الوقت الذي تشيخ المجتمعات وتتقادم العصور، ينبجس نور القرآن وكأنه في ريعا شبابه، كله حيوية وقوة وصلابة.”إن القرآن الكريم قد حافظ على شبابيته وفتوّته حتى كأنه ينـزل في كل عصر نضِراً فتياً. نعم، إن القرآن الكريم، لأنه خطاب أزلي، يخاطب جميع طبقات البشر، في جميع العصور خطاباً مباشراً، يلزم أن تكون له شبابية دائمة كهذه. فلقد ظهر شاباً، وهو كذلك كما كان. حتى إنه ينظر إلى كل عصر من العصور المختلفة في الأفكار والمتباينة في الطبائع، نظراً كأنه خاص بذلك العصر، ووفق مقتضياته، ملقناً دروسه ملفتاً إليها الأنظار”.
بهذه المواصفات الكبيرة، يصبح للرسالة المحمدية بعد إنساني عظيم يتناغم فيه الزمان والمكان خدمة لهذا للإنسان. هذا البعد قد تكون الحكمة الربانية متمثلة في المكان أو اللغة أو غير ذلك من الأبعاد التي تهم الجنس البشري. وأن جمع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لما تفرق لدى أنبياء باقي الشعوب والمجتمعات والعصور، يشير بطريقة تلقائية إلى أهلية رسالته لقيادة الإنسانية اليوم. إن الأستاذ كولن وضح ذلك وبإسهاب، حين أضاء قوله تعالى: ﴿اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ ولادة الإسلام ورسالته في مكة ثم انتشاره في أرجاء العالم بعد ذلك مبنية على حكم عديدة. وكما يمكن تقييم الآية الكريمة ﴿اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ من هذه الزاوية أيضاً، يمكن تقييمها أيضاً من الناحية الإنتروبولوجية والجغرافية والتاريخية والإنسانية ومن ناحية المكان واللغة وسائر الأبعاد الأخرى للمسألة. أجل! إن الله تعالى هو أعلم بمن يختاره لنبوته ولرسالته، وفي أي مجتمع يظهر رسوله. كما أنه هو الأعلم متى يظهر رسالته وفي ضمن أي جو من الصراع الدولي والديني والإنساني وبعد بلوغ هذا الصراع أي مستوى يرسل رسولاً جديداً وديناً جديداً…أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان برسالته العالمية الشـاملة جامعاً لأفكار جميع الأنبياء العظام للإنسانية ورسالاتهم. ..لذا كان على الإنسانية جمعاء تنظيم جميع قضاياها الحيوية في ضوء هذه الرسـالة الأخيرة وعلى هداها”.
كما أن للبعد المكاني في هذه الرسالة إشارات قوية إلى أن قيادتها للإنسانية حينها، كانت نموذجية. فمعلوم أن مكة المكرمة تحيط بسُرة الأرض. والكعبة سُـرة الأرض وقلب الوجود. جانب الآخر من المسألة هو أن مكة كانت بلدة استراتيجية من وجوه عدة، إذ كانت ملتقى عدة دول آنذاك… وهكذا كانت مكة والمدينة مهدين لمثل هذه الحضارات القديمة كما كانتا على علاقة بمدنية بيزنطة في روما ومدنية الساسانيين في إيران. وقد التقت ثقافة روما بواسطة مدينة انطاكيا، مع ثقافة مصر القديمة “أنتجت” أو “أنجبت” مدينة الإسكندرية التاريخية.. كانت روما تعد آنذاك القوة العالمية العظمى، وقد نـزلت سورة “الروم” في حق القوى العظمى في تلك الأيام…لذا يمكن القول من هذه الزاوية بأن الجزيرة العربية كانت أرضاً ملائمة لتقديم رسالة الإسلام العالمية. أجل إن رسالة تخاطب العالم أجمع يجب أن تنبثق من مكان بحيث ما أن تظهر هذه الرسالة للوجود حتى يكون بالإمكان نشرها في العالم. إن ظهور الرسول محمد صلى الله عليه وسلم برسالته العالمية الشاملة في ذلك المكان المبارك، في مكة المكرمة أمر هام جداً.
حين يتكلم القرآن عن قضية معينة، فإن المتأمل لهذه الآيات ينتابه شعور قوي وإحساس عجيب تجاه هذه الآيات. بل قد نضطر في كثير من الأحيان أن نومن بأننا نحن المقصودون بالخطاب وبذلك يمكن الاستفادة الصحيحة من هذا الكتاب. وبهذا المنهج نُعولم القرآن بطريقة تلقائية، فتصبح قضاياه وتوجيهاته ونظمه موجهة للإنسانية جمعاء. وهذا سحر عجيب في هذا القرآن لا يمكن أن يزاحمه فيه غيره. يقول الأستاذ كولن حين تأمله في قوله تعالى: ﴿وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ * أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ * وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ * إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا َعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ : ” … والقرآن عندما ذكر الشعراء في هذه الآية إنما كان يعني هؤلاء الشعراء الجاهليين. وأن وصف القرآن للتابعين لهؤلاء الشعراء والمتأثرين بهم بأنهم “غاوون” يشير إلى مدى انحراف هؤلاء الشعراء. من جهة أخرى تخاطب هذه الآية بعض الشعراء في كل عهد وإن لم يكن بدرجة خطابه لشعراء العهد الجاهلي. فإن قومنا آية ﴿وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ﴾ ضمن هذا الإطار نراها تشير إلى الذين أبعدوا الدين وكل ما يتعلق به عن حياتهم، واتخذوا أهواءهم أصناماً واتبعوا أمثال هؤلاء الشعراء. وكما رأينا فإن من أهم شروط الاستفادة من القرآن قبوله رسالة عالمية لكل العصور، وقراءة كل إنسان له وكأنه يخاطبه. في هذه الحالة فقط يستطيع القرآن التعبير عن نفسه. ونستطيع نحن الاستفادة منه.
هم صلاح الإنسانية هاجس لا يفارق الأستاذ كولن، وحرصه على تحقيق التوازن في هذا العالم صلب مشروعه الكبير. ورحمة بالناس جعل اله تعالى الميل إلى هذا التوازن ميلا فطريا في نفوسهم. إلا أن تحقي هذا التوازن وتربية هذا الميل يحتاج إلى جنود مؤمنين بهذا الطريق مستعدين للتضحية في سبيله.هذا ما يبدو من خلال رؤية الأستاذ حين توضيحه لقوله تعالى:(وَلَوْلاَ دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَكِنَّ اللهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾البَقَرَة:251. يوجه الله تعالى أنظارنا في هذه الآية الكريمة -علاوة على أمور عدة- حول وجود ميزان وتوازن ومقياس في عالم الإنسان كوجوده في عالم الطبيعة والبيئة. فكل شيء قد وضع له نظام ومقياس معين وقواعد معينة. لذا ومن أجل تأمين مثل هذا التوازن لحساب الإنسانية ومن أجلها يهدينا الله تعالى إلى سواء السبيل ويخلق في جوانحنا الميل نحو الكفاح في هذا السبيل. ذلك لأن هذه النتيجة يجب أن تتحقق بيد الإنسان في دائرة الأسباب، …. فإن لم يكن هناك أناس قد طوروا مشاعرهم الإنسانية بالإيمان والإسلام وأصبحوا جنوداً للحق وللنظام، ناشرين الأمن والطمأنينة كانت الدنيا عالماً للمتجاوزين حدودهم والمعتدين وسـاد الظلم والذلة فيها.
وكذلك على المستوى الدولي فإن عدم الاهتمام بتحقيق هذا التوازن وغياب أهله، فإن ذلك يعني فتح لباب الفوضى والظلم، بل هو هزيمة نكراء للإنسانية. حيث فقدان الأمن والثقة بين الدول وبين المجتمعات تكون مفقودة وتصبح الأمور في يد الدول الغالبة والمفسدة. وهذا معناه هزيمة الإنسانية وتقلبها في أحضان الفساد والفوضى. في مثل هذا الجو يكون الناس ذئاباً ويرى القوي أن الحق بجانبه على الدوام، ويضع القوانين حسب أهوائه، أي يحاول أن يقيم عالماً تسود فيه فلسفة عرجاء ومشاعر أنانية .
والأستاذ كولن لا يمل من التأكيد على أهمية الكلمة وقوتها في عالم اليوم. ويرى أن القوة الحقيقية هي قوة العلم والكلمة ليس درجة العنف. لذا ليس أعظم من التلطف منهجا لكل من يلج هذا الطريق، وأن أول شروط الخدمة الإيمانية يكمن في التواضع الكبير. كل ذلك لأن العالم الآن قد تمدن وتحضر في معظمه، لذا فالغلبة الآن تتم عن طريق الإقناع وعن طريق العلم وعن طريق المحاورة والكلام أكثر مما تتم عن طريق القوة والعنف. وفي مقابل هذا فقد نمت الفردية بين الناس وضعفت العلاقات الرابطة بينهم. وبما أنه أصبح الدور الآن هو دور الجماعة والشعور الجماعي أكثر من دور الأشخاص والأفراد المتميزين والفريدين، فإن المطلوب ليس التصرف برحمة وشفقة نحو المؤمنين بل بأسلوب أكثر لينا وتواضعا، أي أذلة على المؤمنين،لا يقابل الشتم منهم إلا بالسكوت ولا يقابل عدوانهم إلا بالصبر، أي يضع رأسه تحت أقدام المؤمنين. ودرجة الرحمة المطلوب تأسيسها بين المؤمنين أعلى بكثير من درجة الشدة المطلوبة نحو الكافرين والملحدين. علماً بأن أول شرط في تأسيس الوفاق في هذه الخدمة المدنية بعد حب الله وابتغاء رضاه هـو تأسيس جو هذا التذلل بين المؤمنين. أي حال التواضع الشديد. ومهما بذلنا من جهد في هذا السبيل فلن يغلى على هذا الهدف. ونستطيع أن ننظر إلى نصيحة الأستاذ النورسي بضرورة قراءة رسالة الأخوة والإخلاص كل أسبوعين مرة في الأقل من هذه الزاوية. و يحتمل أن أكبر امتحان لنا سيكون في موضوع علاقات الأخوة الموجودة فيما بيننا.
تأكيدا منه لهذا التوجه الإنساني، يحث دائما على مقابلة الأفكار المخالفة بالحوار والإقناع لا بالشدة. دون إغفال للحرج الشديد الذي قد يقع فيه أهل الخدمة في هذا الدرب الطويل. لذا فتحفيزه لهم دائما حاضر، وتذكيره بأن دينهم هو السبب الوحيد للعزة ولا التفات لمن يستهين بهم. كل ذلك لأن الآية تقول بأن المؤمنين يكونون ﴿أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ وهذا حسبما نفهم شيء أقل من الشدة. وكما قلنا أعلاه فإن مقابلة الأفكار المعادية في عصرنا الحالي والتغلب عليها يكون في الأكثر عن طريق الحوار والإقناع وليس عن طريق استعمال الشدة… وكما نعلم جميعا فقد جاء وقت استهين فيه بالمؤمنين، وأصبح قول “إنني مسلم” سببا للاستهانة والتحقير. لذا رجحنا في طريق خدمتنا الإيمانية عدم الالتفات للجاه أو المنصب أو البزاتالرسمية أو العناوين والرتب، بل اعتبرنا الإسلام السبب الوحيد للعزة…وبهذا الشعور نقوم بوظيفتنا في الإرشاد في البيت والمدرسة وفي السوق والشارع، وفي أي مكان نوجد فيه، .. وعندما يعدد القرآن صفات هذه الجماعة يقوم بالإشارة إلى بعض الحوادث الجارية في زماننا بشكل إعجازي.
مُكوت الأستاذ الطويل لإيضاح المعاني السامية التي تزخر بها هذه الآية ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ﴾ يبين مدى اهتمامه بالجانب الإنساني فيها. وشدة تحوطه من كل ما قد يشوش على مشروعه الإنساني الكبير. فراح يعصر منها المعاني الواحد تلو الآخر. وما كان ليفعل ذلك لولى خبرته بالطرق الدلالية المتنوعة. محذرا من الرؤية التجزيئية للنصوص التي تعد أرضية خصبة للتطرف. “إن عدم معرفة سعة دعوة الإسلام ودعوة التوحيد وعمقها وسمة التدرج فيها حق المعرفة بمثل هذا المقياس وعدم معرفة إستراتيجيتها في بناء الجسور مع مختلف طبقات الشعب وأقسامه، والوقوع في فهم خاطئ في هذا الصدد أدى إلى ابتعاد الكثيرين عن الإسلام. وكانت النتيجة مظهراً مختلفاً بل مضاداً ومخالفاً تماماً لروح هذا الدين الذي يملك قوة جذب قوية تجذب الناس إليه. فمن جانب تم تشويه الرأي العام وتطلعات الجماهير، وسادت العجلة -التي هي من سمات الضعف البشري- كل شيء وأهملت قاعدة التدرج، والأهم من هذا أنه أهمل ترتيب الخطوات المتتالية المذكورة في هذه الآية، حيث تم البدء من نـهايتها ومن فقرتها الأخيرة. وكانت النتيجة التورط في اتجاه اعتبرته الجماهير اتجاهاً متطرفاً… مع أن الآيات إن دققت جيداً تبين بأنـها تقيم فقط الجسور مع أهل الكتاب وتفتح الأبواب أمامهم . أما ما يتم بعد دخول هذه الأبواب فلا يصرح به، بل تقوم آيات أخرى بذلك”.
عصر الانبعاث الذي سيضيء طريق الإنسانية جمعاء، هم راود الأستاذ كولن ولا زال يقض مضجعه، ذلك ما يفهمه كل متتبع لأقوال هذا الرجل وأفعاله. لكن واسطة عقد هذا المشروع هو الإنسان الذي هو إنسان بالفعل لا بالقوة، لكن غيابه في عالم اليوم سيُبقينا بعيدين عن التطلعات التي تليق بالإنسان الذي كرمه الله وهيأ له كل أسباب الرفاه والعيش الكريم في الدنيا وفي الآخرة لكن هذا المخلوق الضعيف مصر على أن ينسى كل الأسباب والأفعال التي تحقق إنسانيته. ” نحن اليوم على مشارف عهد جديد في مسيرة تاريخ الإنسانية، متفتح على تجليات العناية الربانية. لقد كان القرن الثامن عشر، بالنسبة لعالمنا، قرن التقليد الأعمى والمبتعدين عن جوهرهم وكيانهم؛ وكان القرن التاسع عشر، قرن الذين انجرفوا خلف شتى أنواع الفانتازيات واصطدموا بماضيهم ومقوماتهم التاريخية؛ والقرن العشرون، كان قرن المغتربين عن أنفسهم كليا والمنكرين لذواتهم وهويتهم، قرن الذين ظلوا يُنقّبون عن مَن يرشدهم وينير لهم الطريق في عالمٍ غير عالمهم. ولكن جميع الأمارات والعلامات التي تلوح في الأفق تبشر بأن القرن الواحد والعشرين، سيكون قرن الإيمان والمؤمنين، وعصر انبعاثنا ونهضتنا من جديد” .
هكذا هو هذا الرجل شديد الهمة كبير الطموح عميق الرؤية بعيد النظر. لعل همه الرسالي جعله يجري والناس تسير حتى طوى المسافات وعبرها التجارب والثقافات، معتبرا بالتاريخ أشد الاعتبار، عاملا على تجديد المسار الإنساني المتعثر ليل نهار، لكن ليس بأي منهج بل بالاعتماد على الإمكانات الذاتية والتعويل على الثقافة الملية والرسالة المحمدية الإنسانية. كل ذلك عبر إصرار غريب على أن القرن الواحد والعشرين هو قرن الدين الإنساني، الإسلام. إلا أن هذا العالم الإنساني الجديد باهض الكلفة عزيز المنال حاجته إلى إنسان جديد ماسة، وتعويله كبير على مواصفاته الخاصة. فرؤية الأستاذ فتح الله إذا تدل على أنه وضع كل الأمور في نصابها وأن يده على الزناد، فاستمع إليه يقول: “… الإنسان الجديد متشبع بحب الوجود كله، حارس للقيم الإنسانية وراصد لها. فهو من جهة يحدد موقعه وينشئ ذاته على أساس الأخلاق والفضيلة التي تجعل من الإنسان إنسانا مثاليا، ومن جهة أخرى يحتضن الوجود كله بقلبه الواسع وشفقته الشاملة، ويسعى دائما من أجل إسعاد الآخرين. وفي الوقت الذي يقوم بوضع المعايير لنفسه، يقوم أيضا بوضع مقاييس حول كيفية التعامل مع الأشياء والناس الذين كتب عليه العيش معهم؛ وإذا ما سنحت له الفرصة سعى جاهدا لتحقيق معاييره وخططه التي وضعها. فهو لا يتوانى أبدا عن متابعة كل ما هو إيجابي فيما حوله وعن الحفاظ عليه، وحث الآخرين على ذلك… وهو يشن حربا على كافة المساوئ، وهو كالقوس المشدود، مستعد دائما لإزالة هذه المساوئ واقتلاعها من تربة المجتمع الذي يعيش فيه.”
وفي الختام إن عجبت فلا تعجب من قول هذا الرجل الكبير، أنه مهما صدر من الظالمين والمفترين والمعتدين فهؤلاء أيضا من بني البشر وينتسبون إلى الإنسانية. لعمري إن الإنسانية جمعاء عاجزة أن تجد أبلغ من هذا الرجل قيلا ولا أعمق منه تفسيرا و لا أكثر منه حرصا، بعد الله غز وجل وما نزله من رسل وأنبياء، على مصلحتها وحسن مآلها في العاجل والآجل. وإليك أيها القارئ الكريم، هذه الكلمات التي تعد غيضا من فيض ما صدح به هذا البلبل النائح في كثير من المناسبات:
“أمام صوتي -ومنذ سنوات- تتزاحم صراخاتُ الصمت.. فأكاد أصْرخ بلعن الظلم، والبصق على وجه الظالم، وبإفحام المفتري، وقطع صوت المعتدي، وبزجر الكذّاب المفتري، والقوْل لهم: “أما آن لكم أن تكفّوا؟!”… ولكن لكون هذا ضد طبيعتي، فلا أقول بل لا أستطيع لفظ أيّ شيء لأحد.. لأنني أدرك أن الله تعالى يرى ويعلم كل ما يقع، فأربط الأمر بعدالة القدر الإلهي المطلقة، وأكظم غيظي، وأُودِع قلبي حدتي النابض بالحب على الدوام، وانسجامًا مع فكري وأسلوبي أقول: “لا حول ولا قوة إلا بالله” تجاه من يخطط الأمور ويسرد ما يعنّ له من أقوال يختلط فيها الصدق مع الكذب، وأتَمْتم: “رضينا، حتى بهذا!” مكتفيًا بهذا.. صحيح أن مثل هذا التصرف سيشجّع الظالمين، ويزيد من جرْأة المفترين، ويقود المعتدين إلى مزيد من الاعتداء… ولكني أرجع إلى نفسي فأقول: “مهما كان، فهؤلاء أيضًا من بني البشر، ربما يخطر ببالهم يومًا ما أنهم ينتسبون إلى الإنسانية، فيرجعون إلى أنفسهم ويكفّون عن هذه الخزعبلات، ويعودون إلى الإنصاف.. قد يكون هذا نوعًا من حسن الظن، أو أملاً بعيد المنال، ولكن لا أملك سوى انتظار ذلك اليوم المأمول… أنتظر محاولاً تخفيف الآلام التي تعصف بمشاعري، وجاهدًا لتخفيف غلوائها، بل قد أدلف إلى صمت عميق أراقب نفسي، وأحاول الخروج من عالَم مشاعري”